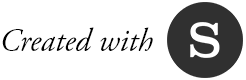داخل عقل الجنرال
هكذا فكر السيسي حتى أوصل مصر إلى طريق مسدودة، والخيارات المتاحة أمامه..

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتظر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بفارغ الصبر داخل غرفة مزخرفة ببذخ في «فندق القصر» Hôtel du Palais، خلال قمة مجموعة السبع التي عُقدت في شهر أغسطس/آب 2019 بمدينة بياريتس الفرنسية، عندما سُمِع وهو يقول: «أين الديكتاتور المفضل لديّ؟».
ترامب قال ذلك بصوت عالٍ بما يكفي لتسمعه المجموعة الصغيرة من المسؤولين الأمريكيين والمصريين في الغرفة الصغيرة.
المسؤولون الذين اعتقدوا أن الرئيس الأمريكي قال جملته مازحاً، سادهم صمت رهيب في القاعة الصغيرة، فقد كان السيسي يهمُّ بالدخول ولم يُعرف ما إذا كان سمع العبارة التي قالها ترامب أم لا.
بعد الاجتماع، وقف الرجلان أمام كاميرات المصورين. كانت ابتسامة ترامب عريضة كعادته، بينما كان السيسي يجاهد لكتم سعادته المفرطة في الصورة التي نشرها ترامب نفسه عبر حسابه على تويتر.
وفدا الدولتين أيضاً كانا يقفان وجهاً لوجه أثناء التصوير. لم تبدُ الوقفة مريحةً بعد عبارة ترامب التي لفتت الانتباه إلى جانب غير مريح في العلاقات الأمريكية - المصرية.
فعلى طرفٍ، وقف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، ومستشار الأمن القومي آنذاك جون بولتون الذي استقال أخيراً، ولاري كودلو مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية، وجميعهم يتأملون الكاميرا، بينما على الطرف الآخر وقف وزير الخارجية سامح شكري مطرقاً رأسه لحظتها نحو الأرض، وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، متأملاً الوفد الأمريكي، وإلى جانبه مسؤول مصري آخر.

اجتماع ترامب والسيسي في فندق القصر بفرنسا
اجتماع ترامب والسيسي في فندق القصر بفرنسا
احتفى ترامب أمام الصحفيين -من بين تعليقات أخرى- بعلاقته بالسيسي. وأعاد الجمل ذاتها التي قالها قبل عامين تقريباً؛ بأنهما قد بدءا التحدث بعد وقت قصير من فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2016 وأنهما يفهمان بعضهما البعض جيداً، إلخ.
الرئيسان لم يعلما أنه بعد نحو ثلاثة أسابيع من الآن، سيدخل السيسي في واحدٍ من أصعب الاختبارات منذ الانقلاب الذي قاده ضد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، بعد الفيديوهات التي نشرها رجل الأعمال المصري محمد علي، وأن أمواج التغيير التي تنتظر مصر تشبه الأمواج المتلاطمة المعروفة في خليج غاسكونيا المُطل عليه الفندق الذي كان يوماً قصراً صيفياً تستخدمه واحدة من أجمل نساء فرنسا: الإمبراطورة أوجيني.
على الأرجح، يعلم الرئيس السيسي ( 64 عاماً) أن أوجيني هذه -التي صعدت صعوداً درامياً ثم سقطت بنهاية درامية أيضاً- كانت قد زارت مصر بدعوة من الخديوي إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة السويس عام 1869. جاءت وحدها دون الإمبراطور الذي كان مشغولاً بالظروف السياسية التي تمر بها فرنسا حينها. بالغ الخديوي في الاحتفاء بها، كانت في الثالثة والأربعين من عمرها، بالغة الأنوثة والتألق والجمال، وقد عبرت الإمبراطورة نفسها عن البذخ والترف في الاحتفالات بقولها: «لم أرَ في حياتي أجمل وأروع من هذا الحفل الشرفي العظيم».

الإمبراطورة أوجيني
الإمبراطورة أوجيني
بعد هذه الزيارة بـ146 عاماً، أعاد السيسي افتتاح السويس عام 2015 بحفل باذخ أيضاً في توسعة جديدة للقناة لم يجد الاقتصاديون جدوى اقتصادية لها. ومن هنا بدأت مشاكله الحقيقية.
فما هي الحكاية؟
منذ أن وصل الرئيس السيسي إلى الحكم في مايو/أيار 2014، وإحكام قبضته على البلاد، لم يُسمح سوى بمعارضة قليلة، ولسخرية الأقدار بات هذا القليل تكلفته باهظة على السلطات المصرية وعليها أن تدفع ثمنه الآن، عندما دعا -بما فاق التوقعات- آلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد إلى إسقاط السيسي في موجة من الاحتجاجات المتناثرة ليلة الجمعة والسبت 20 سبتمبر 2019.
كان الدافع الظاهر للاحتجاجات غير متوقع تماماً، محمد علي، مقاول البناء (45 عاماً) والممثل غير المتفرغ، الذي يقول إنه حصل على مشاريع بناء ثرية للجيش المصري، وكان قد غادر إلى إسبانيا ليعيش في المنفى الاختياري، حيث بدأ بنشر مقاطع فيديو على الشبكات الاجتماعية يتهم فيها السيسي بالفساد والنفاق، وهي عكس الصورة التي يروج بها الرئيس لنفسه.
في الأسابيع الثلاثة الأخيرة منذ ظهور شريط الفيديو الأول، أعاد محمد علي طرح نفسه باعتباره كاشفاً للأسرار، ومعارضاً للسيسي ومثيراً للاحتجاجات، وقد حوّلته قصصه عن الفساد في قمة هرم السلطة في مصر، إلى صوت بارز معارض للرئيس. وعندما اندلعت الاحتجاجات، كانت في الوقت والتاريخ اللذين حددهما من منفاه.
لكن مدى تأثير محمد علي وقدرته المفاجئة على التحفيز لا يزالان محل اختبار بعد أن دعا إلى مظاهرات قادمة رغم تشديد السلطات للإجراءات الأمنية واعتقال الآلاف. وأثار صعوده الغامض إلى الصدارة أسئلةً في مصر وخارجها حول ما إذا كانت شهرته المفاجئة قد جاءت بدعم ـ أو ربما استغلال ـ من أصحاب المصالح القوية في البلاد، الذين تضررت مصالحهم داخل الحكومة أو خارجها بسبب حركات استبعاد غير دقيقة ارتكبها السيسي ضد هؤلاء.
فمن هو محمد علي هذا، ومن الذي يدعمه، وما الذي دفعه للخروج بهذه الاتهامات الآن ضد الرئيس؟ من الواضح أن له ارتباطات، لكن من هم هؤلاء بالضبط؟ والأهم من كل ذلك: يرى بعض المحتجين على الأقل، أن محمد علي لم يكن مُلهماً بقدر ما قدم فرصة للتعبير عن إحباطاتهم المتتالية.
«الأسرار» التي كشف عنها لاقت صداها لدى الكثير من المصريين الذين شاهدوا السيسي يقيم مشاريع البناء الضخمة بينما تنهار أوضاعهم المالية. فقد ذكر تقرير للحكومة المصرية في يوليو/تموز الماضي أن واحداً من كل ثلاثة مصريين يعيش تحت خط الفقر.
أن يخرج الآن شخص مثل محمد علي لإنقاذ الفقراء، بحُسن مظهره وصوته الأجش، غير متعلّم إلا تعليماً متوسطاً، صنع ملايينه بنفسه، فإن صداه بينهم -بحسب المحللين- سيكون واسعاً وسيُنظر له على أنه بطل شعبي لا يتحدث بلغة الناشطين، إنما بلغتهم، أو ربما بلغة الشخص الذي يريدون أن يكونوا مثله.
كيف إذاً أوصل السيسي -الذي بات العقدة التي تجتمع عندها خيوط اللعبة في مصر- نظام حكمه إلى هذه النقطة التي أشبه ما تكون بنهاية مغلقة؟ وكيف سيرد على الاحتجاجات إذا استمرت؟
لعل الإجابة على السؤالين السابقين تكمن أصلاً في كيف ينظر السيسي إلى نفسه؟ قد يبدو الجواب سهلاً واضحاً للكثيرين؛ فالرجل الذي عاش في بيئة محافظة، وفرض الكثير من الخصوصية على حياته الشخصية، وأمضى الفترة الأخيرة قبل وصوله إلى الحكم مديراً عاماً للمخابرات الحربية، كشف خلال فترة حكمه أكثر مما ينبغي. لكن قبل الركون إلى استنتاج جامع مانع، دعنا نخوض هذه الرحلة في استكشاف السيسي -الرجل الذي لا تعرفونه حقاً، جذور شخصيته، كيف تطورت هذه الشخصية، وبالتالي ردود فعله المتوقعة على الاحتجاجات.

رجل مخابرات علني، ورئيس لا سياسي، وقائد يلهمه الإله
المخاض الذي أفضى لولادة وحش

تمتع السيسي الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري أدى إلى مذبحة أودت بحياة أكثر من 1000 شخص من أنصار سلفه مرسي، بسُمعة طيبة -على الأقل بين مناصريه والدبلوماسيين الغربيين- لهدوئه الشديد. فهو عند التحدث معه «على عكس معظم الجنرالات، يستمع»، هذا ما قاله دبلوماسي أوروبي لصحيفة نيويوركر الأمريكية. ولعل السيسي كان الأكثر براعة في هذا. الحضور الهادئ والموقف المنطوي غالباً يدفع المستمعين للتفكير فيما يقوله الشخص. وتكون الرسالة الضمنية دائماً أنْ انظروا: هل هناك معنىً أعمق مما يُقال؟
غالباً ما تقوم الثورات بالأشخاص الجريئين الذين يعبرون عن آرائهم علناً وصراحة، ثم يسيطر عليها أولئك الذين يتسمون بالهدوء والحذر. فالشهرة والبروز المبكريْن عادة لهما ثمنهما، وفي كثير من هذه الحالات يكون الفائز هو ذاك الذي يجلس هناك منتظراً ومترقباً الفرصة المؤاتية.
في فبراير/شباط 2011، عندما أجبرت مظاهرات ميدان التحرير الرئيس حسني مبارك على التنحي، كان السيسي مديراً للمخابرات الحربية، وهو منصب كان غير مرئي فعلياً للجمهور. قبل ذلك بخمس سنوات، أكمل دورة في الكلية الحربية التابعة للجيش الأمريكي في كارلايل بولاية بنسلفانيا. ولم يلحظه أحد من كبار المسؤولين الأمريكيين طوال تلك الفترة. وذكرت صحيفة نيويوركر أن ليون بانيتا، الذي أصبح وزيراً للدفاع الأمريكي خلال عام الثورة في مصر، وكان سابقاً مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية، قال: «لا أتذكر أي نوع من الاهتمام في تقارير المخابرات بالسيسي». لم يعرفه المسؤولون الأمريكيون العسكريون، وكانت المعلومات المتعلقة بسيرته الشخصية ضئيلة للغاية. وقال تشاك هيغل الذي خلف بانيتا في إدارة وكالة الاستخبارات المركزية، للصحيفة ذاتها: «الناس لا تعرف الكثير عن زوجته، ولا تعرف عن أطفاله. لا أعتقد ذلك من قبيل الصدفة. أعتقد أنه كان متعمداً في بناء هالة حول نفسه».
كان السيسي الضابط الأصغر سناً في المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد تنحي مبارك مباشرة. ويقال إنه قام بدور قيادي في المحادثات السرية بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين. علاقة الجماعة مع الجيش كانت متوترة، ولكن خلال فترة ما بعد ميدان التحرير، وصعود الجماعة إلى السلطة من خلال سلسلة من الانتخابات الشعبية، كانت هناك دلائل على أن هناك ترتيباً ما يجري إعداده. وكان دور السيسي أن يخلق نوعاً من «التعايش» بين الجيش والجماعة، فطالما لا يتدخل الإخوان أكثر من اللازم في الشؤون العسكرية فإن الجيش سيسمح لهم بالاستمرار في القيام بأعمال الحكومة المدنية.
وَثَق قادة الإخوان في السيسي جزئياً لأنه كان مسلماً ملتزماً. وفي البدايات على الأقل، بدت القيادة العسكرية أنها تلتزم بـ«الصفقة» المعقودة بين الطرفين. ففي يونيو/حزيران 2012، عندما فاز محمد مرسي بأول انتخابات رئاسية ديمقراطية في مصر لم يتدخل الجيش. ولم يمضِ وقت طويل على توليه منصب الرئاسة حتى أجبر مرسي وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، ورئيس الأركان سامي عنان، على التقاعد، إلى جانب قادة البحرية والدفاع الجوي والقوات الجوية. وقد أشاد بهذه الخطوة الثوار المصريون الشباب الذين رأوا أنها علامة على أن مرسي مصمم على الحد من نفوذ الجيش. وشجع الكثير من الناس أيضاً اختياره وزير الدفاع الجديد: السيسي. في سن السابعة والخمسين، حل السيسي مكان جنرال يبلغ من العمر ستة وسبعين عاماً، وبدا أن التعيين يعكس انتقال المسؤوليات إلى ضباط أصغر سناً وأكثر تنوراً.
مرسي حاول أن يقوم بخطوة جريئة أخرى. في نوفمبر/تشرين الثاني أصدر مرسوماً رئاسياً عزز فيها صلاحياته، كخطوة استباقية على أية معارضة لدستور جديد قادم بطابع إسلامي. أثارت هذه الخطوة حفيظة بعض مجموعات الثوار من غير الإسلاميين، ونمت معارضة بشكل مطرد خلال الأشهر الستة التالية. خلال هذه الفترة، لم يُدلِ السيسي إلا ببعض البيانات العامة، لكنه فتح حواراً مع نظيره تشاك هيغل في البنتاغون. في مارس/آذار 2013، عندما كانت الأزمة تزداد سوءاً، زار هيغل القاهرة، حيث التقى بالسيسي لأول مرة. وقال هيغل لـ«نيويوركر»: «كانت الكيمياء بيننا جيدة جداً».
مع تفاقم الأزمة، أصبح هيغل الشخص الوحيد في الحكومة الأمريكية الذي يتواصل معه السيسي. جرت بينهم نحو 50 مكالمة كانت بعضها تمتد لساعات. وكان الاعتقاد السائد شعبياً أن الجيش يخطط للإطاحة بمرسي، لكن هيغل مقتنع بأن السيسي لم تكن لديه نية في البداية للاستيلاء على السلطة. لم تظهر على الرجل علامات شهوة للسلطة، أو أن يصبح رئيساً. خلال فترات عدم الاستقرار السياسي تكون الدوافع عادة مائعة. لكن دوافع السيسي بدأت تتبلور وتنضج عندما شعر بأن ملايين المصريين يتطلعون إليه "لإنقاذ البلاد".
في الواقع، كان لذلك أثر مدمر ستتكشف أبعاده في مرحلة لاحقة. فالرجل الذي كان يفضل العمل خارج الأضواء والابتعاد عنها نتيجة تربيته الأسرية المحافظة، وشخصيته المخابراتية بحكم عمله في المخابرات الحربية، أصبح الآن في دائرة الضوء.
في يونيو/حزيران 2013، خرج الملايين إلى الشوارع احتجاجاً على الحكومة. وكان السيسي يقول لصديقه هيغل: «ماذا يمكنني أن أفعل؟ لا يمكنني تجاهل الأمر. لا أستطيع أن أخيب بلدي. يجب أن أقود. لديّ مناصرون. أنا الشخص الوحيد في مصر اليوم الذي يمكنه إنقاذ البلد».
حتى النهاية، بدا قادة الإخوان مقتنعون بأن السيسي إلى جانبهم. وعلى الأرجح كان مرسي قد اندهش تماماً عندما انقلب السيسي ضده. في 3 يوليو/تموز أخذ الجنود الرئيس مرسي إلى الحجز، وظهر السيسي على شاشات التلفزيون ليعلن أن حكومة مؤقتة ستحكم البلاد حتى تتمكن مصر من إجراء الانتخابات وإقرار دستور جديد.
لم تكن الصدمة لدى الإخوان فقط. الحدث كان أكبر من الجميع. حتى السيسي كان يجاهد لاستيعاب كل ما يجري حوله، فخلال الأشهر التي تلت تمتع بشعبية هائلة، وما بين حسّه المخابراتي بالبقاء شخصاً غامضاً يصعب فك شفراته، وبين الطلب الشعبي المتزايد للتعرف عليه أكثر، بدأت تتشكل شخصية السيسي بخلطة من المكونات المخابراتية والسياسية والدينية. فلم يعد رجل المخابرات الذي كان بعيداً عن الأضواء، ولا يريد أن يكون سياسياً كما ينبغي بوصفه مرشحاً رئاسياً (لا يزال حتى الآن يردد: أنا مش سياسي)، واهتزت نظرته لنفسه كمسلم فيما كانت دماء نحو 1000 من المسلمين تُسال، ولا تزال رائحتها طازجة أمام منخريه، حتى أنه قال لهيغل نفسه إن زوجته وأسرته مضطربة لما رأوه في مذبحة رابعة.
ولكي يكون على قدر المهمة التي تنتظره، طوّر السيسي رؤيةً فريدةً عن نفسه، بأن ما قام به إنما كان بإرادة إلهية، وإن العناية الإلهية ذاتها هي مصدر قوته (ظهر ذلك واضحاً في تسريبات حواره مع ياسر رزق حول أحلام السلطة التي راودته طوال 35 عاماً)، وستغذي وسائل الإعلام المؤيدة هذه الرؤية، لتدخل دائرة جهنمية: السيسي يظن أنه هكذا، الإعلام يؤكد أنه هكذا، السيسي يؤمن أنه هكذا.
ستنضج هذه الرؤية رويداً رويداً في السنوات التالية، إلى أن تصبح وبالاً على المصريين أنفسهم الذين أوصلوا شخصاً بهذه التركيبة النفسية لسدة الحكم، حتى يكاد يكون أقرب للوحش.






العارف بكل شيء، كُلّيّ القدرة، والملهم المعزول
الوحش الذي يريد صياغة المجتمع على شاكلته





في مايو/أيار 2014، وصل السيسي إلى سدة الحكم. ورغبة منه في ممارسة السلطة الكاسحة التي منحته إياها العناية الإلهية، قام بعمليات قمع واسعة طالت السياسيين والناشطين، وأذعن وسائل الإعلام وسجن جحافل من المعارضين.
ومنذ أن أصبح رئيساً، كشف السيسي من دون قصد عن نفسه وعن الهياكل السياسية في مصر أكثر مما كان يتصور أي شخص داخل مصر وخارجها. ففي سلسلة من مقاطع الفيديو المسجلة سراً والتسجيلات الصوتية، المعروفة باسم «تسريبات السيسي« أو «سيسي ليكس»، ظهر الرئيس يتحدث بصراحة عن الموضوعات الحساسة التي تتراوح بين التلاعب بوسائل الإعلام واستدرار الأموال من دول الخليج. وأصبحت انتهاكات حقوق الإنسان أسوأ بكثير مما كانت عليه في عهد مبارك. حتى أن الاحتجاجات التي اندلعت بسبب نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية انتهت بمأساة. وكل ما تطلبه الأمر بالنسبة لرجل مثل السيسي ليصل إلى سدة الحكم في مصر الثورة: السرية والصمت والالتزام بالنظام، جعل من المستحيل عليه أن يسن تغييراً حقيقياً.
وطالما أنه لا يستطيع ولا يريد تغيير النظام، فلماذا لا يغير المجتمع كله بما يتوافق مع مصالح النظام؟
وهذا ما حاول فعله بالضبط. فبعد إذعان وسائل الإعلام، بدأ بمد قبضته الحديدية إلى زاوية جديدة من المجتمع المصري: الدراما التلفزيونية.
ففي كل شهر رمضان يتجمع المصريون حول شاشات التلفزيون في منازلهم بعد الإفطار، لمشاهدة مسلسلات ذات ميزانيات كبيرة يقوم ببطولتها ممثلوهم المشهورون، في أعمال ميلودرامية وبوليسية أو تاريخية، وتُصدّر أفضلها للدول العربية.
لكن في رمضان الماضي مارست السلطات المصرية ضوابط خانقة على هذه المسلسلات وأجور الممثلين، وبدأت تملي على الكُتاب نصوص السيناريوهات، وتولت شركات مرتبطة بالجيش إنتاج أكبر هذه المسلسلات التي تشيد بالجيش والشرطة، أو تشوّه سُمعة الإخوان، وكل مَن لا يلتزم بقواعد هذه اللعبة مُنع من الظهور على شاشة التلفزيون.
قال الكاتب المصري عز الدين شكري فشير لصحيفة نيويورك تايمز: «بالنسبة للسيسي، لا يتعلق الأمر فقط بالسياسة أو السلطة. إنه يريد إعادة تثقيف الجمهور المصري وإعادة تشكيله».
كان حسني مبارك، الذي حكم لمدة 30 عاماً حتى الإطاحة به في ربيع عام 2011 ، يترأس نظاماً قمعياً قاسياً في كثير من الأحيان. مع ذلك، سمح بمساحة لمراكز السلطة الأخرى، مثل الحزب الوطني وهيئة القضاء الأعلى. فبين الحين والآخر، كان القضاة يصدرون أحكاماً تزعجه. وكانت الصحف تنتقده إلى حد ما. حتى أن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة رسمياً فازت في عام 2005 ب 20% من مقاعد البرلمان.
لكن السيسي باقتناعه أن العناية الإلهية التي أوصلته لسدة السلطة التي لم يكن يريدها، أناطته بمهمة إعادة تشكيل المجتمع المصري على شاكلته. فجمع حوله زمرة صغيرة من المستشارين، معظمهم من العسكريين والأجهزة الأمنية وعائلته، تتمتع بنفوذ اقتصادي هائل، وترى العالم من خلال منظور أمني، وسعى إلى القضاء على كل نفس معارض حتى لو كان مجرد بوست على فيسبوك.
يزيد صايغ، كبير زملاء مركز كارنيغي للشرق الأوسط ببيروت، قال لصحيفة نيويورك تايمز: «بصراحة سأشعر بأمان في الحديث حول السياسة في دمشق أكثر من القاهرة». وتابع قائلاً: «إن استبداد السيسي الشخصي يسعى للسيطرة على الفضاء العام بشكل كامل، بحيث لا يجرؤ أحد على قول أي شيء، حتى على انفراد. هذا الخوف هو ما تحاول جميع الأنظمة الشمولية أن تغرسه: عندما لا يستطيع النظام التنصت عليك، يمكنه أن يسمعك».
إيمي هاوثورن، من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط بواشنطن، قالت: «السيسي ليس كيم جونغ أون أو صدام حسين. لكنه يدفع مصر نحو هذا النوع من النظام».
السيسي يبدو عازماً على إعادة تشكيل النسيج الأخلاقي والفكري في البلاد. فقد حاضر في المصريين حول آدابهم ولياقتهم البدنية. الآن يريد تطهير ما يعتبره تيارات فكرية خطيرة. وفي سعيه لممارسة هذه السيطرة المشددة على الدولة والمجتمع المصري، إنما يزرع بذور هلاكه في نهاية المطاف.
وقال صايغ إن الاعتماد على وطأة مثل هذا النظام الثقيل الذي أدى إلى عزل الكثير من قطاعات المجتمع، قد يترك السيسي ضعيفاً في اليوم الذي سيواجه فيه نظامه صدمةً غير متوقعة.
رسم السيسي والجيش صورة لنفسيهما بأنهما قادران على تدمير أي شخص يقف أمامهما. وعندما تأتي اللحظة التي سيحتاجان فيها إلى الآخرين في الحكومة أو البزنس، لن يجدا أحداً ليدعمهما. وبسبب هذا الخوف ينظر السيسي إلى نفسه على أنه «ابن منظومة» الجيش، ولكن أية منظومة؟
الكل يسمع، ومَن لا يُرِد فليسكت
ابن المنظومة الذي هو أكبر من المنظومة ذاتها

من بين العسكريين الأربعة الذين حكموا مصر خلال السنوات الستين الماضية، يبرز السيسي كشخص يفتقر إلى الاهتمام بالسياسة الرسمية. فقد كان جمال عبدالناصر وأنور السادات شابين ناشطين، وكلاهما تغزلا في مرحلة ما بجماعة الإخوان المسلمين قبل أن يرفضا الإسلام السياسي في مرحلة لاحقة. كرئيس دولة، عمل السادات على بناء تنظيم سياسي، أصبح يُعرف باسم الحزب الوطني الديمقراطي، حتى أن مبارك حكم ما كان في الواقع دولة الحزب الواحد باسم حزب السادات ذاته.
في بعض النواحي، يبدو السيسي سياسياً بالفطرة، فخطبه التي يلقيها باللهجة العامية، غالباً ما أثارت إعجاب المصريين العاديين على أنها صادقة ومتعاطفة. لكن غرائزه السياسية شخصية وليست مؤسسية. ولم يكن يهتم بالسياسة في سنين نموه في الحياة.
تضم عائلة السيسي المباشرة 14 أخاً، بينهم أخ غير شقيق. كان والده متعدد الزوجات، رغم أنه لا يُعرف الكثير عن المرأة التي يُشار إليها في الصحافة المصرية ببساطة بأنها «الزوجة الثانية». أما الشخص الوحيد الذي يتحدث عنه السيسي باستمرار ومن دون تردد فهي والدته وأنها المفتاح لفهم شخصيته. توفيت والدته خلال عامه الثاني في منصبه إبان افتتاح توسعة قناة السويس، ووصفها بأنها «امرأة مصرية أصيلة، بكل معنى الكلمة»، وهي نفسها التي ترك جثمانها في الثلاجة عدة أيام كي لا يتغيب عن افتتاح القناة. في عام 2013 سأل صحفي مصري السيسي عما فعله بعد الإعلان عن إقالة مرسي على شاشة التلفزيون. أجاب السيسي: «لقد قرأت البيان، ثم ذهبت إلى أمي»، (وكان رد فعلها بطبيعة الحال: الله يحميك من كل شر!).
بدأ جد السيسي عملاً في صناعة الأرابيسك، والخشبيات المزخرفة بعرق اللؤلؤ. استطاعت العائلة الكبيرة للسيسي السيطرة على تجارة الأرابيسك في خان الخليلي، السوق السياحي الرائد في القاهرة، وما تزال العائلة تمتلك نحو 10 متاجر هناك.
مسعد علي حمامة السيسي (33 عاماً)، الذي يمتلك متجر أرابيسك يتصدره صورة بالأبيض والأسود لجد السيسي جالساً بجلابيته، العصا في يده، والطربوش على رأسه، تحدث لصحيفة نيويوركر عن ابن عمه الرئيس السيسي، وقال إن جميع أفراد الأسرة الذكور في سن المراهقة كانوا يتدربون خلال العطلة الصيفية. والشاب عبدالفتاح السيسي كان يعمل صدفياً، يستخدم سكيناً طويلة لنحت قطع صغيرة من عرق اللؤلؤ. وقال حمامة: «لم تكن لدينا قاعدة أن هذا ابن صاحب الشركة وهذا ابن الرئيس». القاعدة الوحيدة التي كان يتبعها الجميع هي طبيعة العلاقة بين كبار السن والشباب. فالشباب يطيعون الكبار. وإذا جاء أحد كبار السن من العائلة إلى المتجر فإنه يتصرف وكأنه يمتلك المتجر. ورغم أن جذور العائلة ليست من مصر العليا، إلا أن التقليد لديهم هي ذات تقاليد الصعيد.
في مراهقته دخل السيسي إلى مدرسة ثانوية عسكرية. فشكّل هذا الخليط من الانضباط العسكري، والتركيبة الأسرية المتزمتة، والإيمان الديني العميق، شخصية السيسي التي هي تقليدية في أعماقها وبكل المقاييس. تزوّج من ابنة عمه، وهو أمر شائع في مصر بين المحافظين، وزوجته وابنته من ربات البيوت. حتى أن فتحي السيسي، أحد أبناء عمومة الرئيس، قال لصحيفة «الوطن» إن السيسي رفض مرتين مهمات ليكون ممثلاً عسكرياً في الولايات المتحدة، لأن السلطات المصرية طلبت من زوجته خلع الحجاب أثناء تواجدها في الغرب.
كان سقوط النظام السابق بمثابة تحذير للسيسي، فقد كان مبارك يستعد لأن يتولى ابنه جمال مقاليد السلطة السياسية، واستفادت العائلة الممتدة من الفساد على نطاق مذهل. كانت زوجة مبارك (سوزان) منخرطة إلى حد كبير في السياسة، لا سيما لصالح حقوق المرأة، وكثيراً ما أساء دورها إلى الإسلاميين وغيرهم من المحافظين في مصر. بعد الثورة، تم سجن مبارك وأبنائه (أفرج عنهم فيما بعد)، ومما لا شك فيه أن مصيرهم هو أحد الأسباب التي جعلت السيسي يبقي على عائلته بعيدة عن الأنظار، حتى عندما بدأ في منح نجله الأكبر محمود أدواراً برفعه من رتبة رائد إلى رتبة عميد وتوليه وكالة جهاز المخابرات العامة، فقد منحه دوراً غير مرئي لعموم المصريين. وعندما ذكرت الصحف البحرينية أن زوجة السيسي رافقته في زيارة دولة، فاقتبست منها صحيفة «المصري اليوم»، اتصل المكتب الإعلامي للرئيس على الفور بالصحيفة وطلب حذف الخبر.
نتاج تركيبته الشخصية، نظر السيسي إلى نفسه دائماً على أنه ابن منظومة الجيش وليس السياسة. فخلال أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، كان السيسي وغيره من القادة العسكريين حذرين من أحمد شفيق، خصم مرسي، وهو جنرال متقاعد في سلاح الجو وآخر رئيس وزراء مبارك. بالنسبة للسيسي وغيرهم من ضباط الجيش، ربما كان شفيق أكثر تهديداً من مرسي. اعتقدوا أن جماعة الإخوان المسلمين يمكن السيطرة عليها بسهولة، بينما قد يعيد شفيق إحياء حزب يتمتع بقوة حقيقية. حتى بعد هزيمة جماعة الإخوان المسلمين، حرصت السلطات على إبقاء شفيق بعيداً عن العمل السياسي وتهديده قضائياً.
لم يستطع السيسي أن يتحول من القائد العام للجيش إلى سياسي. فهو ينظر إلى السياسة بوصفها عملاً نشاطياً، شيئاً مزعجاً يقسّم الأمة. فمخاطر وجود حزب تفوق فوائده. وبحكم وجوده في سدة الحكم فهو كبير المنظومة، وعلى المنظومة أن تسمعه وتطيعه. وهنا تكمن المعضلة التي ستتكشف أبعادها عن معارضة داخل المنظومة ذاتها.






المملوكي الذي يحكم باسم الفراعنة
عصبة المرؤوسين التي تخوض صراعات الكسب غير المشروع






قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2018، كانت صور الرئيس السيسي المبتهجة تنتشر على اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء مصر. خصومه كانوا في السجون، ووسائل الإعلام في جيبه كما يقال، ولم يقم منافسه الوحيد -السياسي الغامض الذي لم يكن الكثير من المصريين يعرفون حتى اسمه، ولا داعي لذكره هنا أيضاً- بإزعاج نفسه لتنظيم حملة انتخابية.
لم تكن احتمالات خسارة السيسي تتجاوز 1 من 500، وكان معظم المراقبين يتطلعون بالفعل إلى ما بعد الانتخابات: ما إذا كان بإمكان السيسي تغيير الدستور لتمديد حكمه إلى ما بعد الثمانية أعوام.
مع ذلك، كان ثمة سر ما: لماذا كان السيسي يتصرف وكأنه لديه ما قد يخسره.
فمع اقتراب موعد الانتخابات، تصرف الزعيم المصري بطرق بدت متوترة بشكل غريب. في خطاباته كان يتحدث بلهجة غاضبة وتهديدية. ويهذر حول أعداء غير محددين. وخلال ثلاثة أشهر كان للسيسي ثلاثة مستشارين مقربين: قائد الجيش، ورئيس المخابرات، ورئيس هيئة الأركان، قام بعزل اثنين منهم على الأقل بإقالة مدير مخابراته خالد فوزي، وتعيين مدير مكتبه مكانه، وكان قد عزل في أكتوبر/تشرين الأول 2017 رئيس أركان الجيش المصري. فإذا كان كل شيء بيده، مم كان يخاف الرئيس؟
السبب، كما قال الخبراء والدبلوماسيون في القاهرة، يكمن في دوائر القوة الحقيقية في مصر، الأجهزة العسكرية والأمنية التي تشكل حجر الأساس لسلطة السيسي. ورغم أن الانتخابات كانت معدّة لها وأشبه ما تكون بمسرحية، فإنها كشفت عن سخط داخل المؤسسة الأمنية جعلت السيسي يتحشرج في صوته.
تصاعدت التوترات في المراحل الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2018، عندما تقدم جنرالان سابقان إلى الأمام لتحديه. وكان رد السيسي سريعاً عليهما، أودع أحدهما في السجن، بينما تخلى الثاني بعد شهر من الاعتقال عن طموحاته.
لم يكن المحللون يرون أية فرصة واقعية لفوز المرشحين المنافسين للسيسي، لكن ردة فعله عديمة الرحمة على محاولة الجنرالين الدخول في حلبة المنافسة الرئاسية أثارت تكهنات بأنهما كانا يتمتعان بدعم من المؤسسة الأمنية، الأمر الذي اعتبره السيسي بوادر انشقاق لا يمكن التهاون معه. وقال روبرت سبرينجبورغ، الباحث في الشأن المصري في كلية كينغز كوليدج، لصحيفة نيويورك تايمز حينها إن جهاز الأمن الذي أزال سلف السيسي عام 2013 ، يشكل التحدي الحقيقي الوحيد لسلطته. وقال إن الصراع الظاهر حول الانتخابات يعكس ذلك فهي أشبه ما تكون «بظلٍّ يظهر على الجدار، عن الصراع الذي يدور في مكان آخر».
غالباً ما يتم تشبيه الزعماء المصريين المعاصرين بالفراعنة، فكلهم زعماء أقوياء لدولة منضبطة أمنياً. لم يوفر السيسي فرصة لتشجيع هذه الصورة عندما وقف بكامل زيه العسكري على مقدمة زورق يحرث عبر قناة السويس، أو صوره وعلى خلفيتها الأهرامات.
لكن في الواقع هناك تشابه تاريخي أكثر ملاءمة، يكمن في المماليك، وهي طبقة عسكرية منقسمة حكمت مصر في العصور الوسطى، وشكلت بداية دور الانحطاط في تاريخ الحضارة الإسلامية. فعلى مدار ثلاثة قرون تقريباً، حكم السلاطين المماليك من قلعة القاهرة، لكن تفوقهم استند إلى عصبة من المرؤوسين الذين لا يهدأون في خوض المناورات من أجل التفوق والكسب غير المشروع.
في عهد السيسي تتمتع دائرة ضيقة من الجنرالات وقادة الأمن بسلطة اقتصادية وسياسية هائلة، حيث يشرفون على إمبراطوريات الأعمال والإعلام السرية بينما يقومون بحملة شرسة على أي تلميح معارض. وفك رموز طريقة عمل هذه الدائرة يعد أمراً بالغ الصعوبة، حتى أن المسؤولين الغربيين يتعاملون معها بنوع من الكرملينولوجيا أو علم دراسة سياسات كرملين إبان العهد السوفييتي. ولكن يبدو أن انتخابات عام 2018 قد فتحت الغطاء على الضغوط الخفية.
وعلى الرغم من الدعم الذي يتمتع به السيسي من حلفاء أجانب أقوياء مثل الرئيس دونالد ترامب، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لكنه اتخذ العديد من القرارات المثيرة للجدل. فدور الجيش البارز في إدارة الاقتصاد لا يحظى بشعبية لدى رجال الأعمال وبعض الضباط العسكريين أنفسهم. كما أن قرار تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية عام 2016 عارضه العديد من كبار مسؤولي وزارة الدفاع. يمكن للناس أن تحاول تجاوز نقاط ضعف السيسي في مرحلة ما، لكنهم لا ينسون.
كان السيسي قد واجه قبل سنوات معارضة عسكرية - ففي عام 2015، أدانت محكمة عسكرية 26 ضابطاً بتهمة التآمر للإطاحة به. ورغم أن الخبراء يعتقدون أنه يتمتع بدعم من القيادة العسكرية العليا، لكنهم لاحظوا أيضاً أن السيسي يشدد دائرته الداخلية، ويعتمد بدرجة أكبر على عائلته. فقد صعّد نجله محمود سريعاً في جهاز المخابرات العامة وكان محاوراً في اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن. بينما يعمل ابن آخر في هيئة مؤثرة لمكافحة الفساد.
مع الاحتجاجات الأخيرة التي دعا إليها المقاول المصري محمد علي، بدأت تظهر على السطح مجدداً ظلال هذا الصراع. ويتكهن بعض المراقبين بأن محمد علي قد يكون دمية يسيطر عليها -على الأقل جزئياً- كيان آخر، وربما ثمة أشخاص في حكومة السيسي يسعون إلى تقويض أو حتى الإطاحة بالرئيس.
ولم يتردد سامي عنان، الجنرال الذي تم استبعاده في الانتخابات الرئاسية السابقة ولا يزال قيد الحجز، أن يعلن تأييده لهذه الاحتجاجات والدعوة لرحيل السيسي مجدداً. كما ظهر فجأة أحمد شفيق، الذي اختفى بعد إعلان تخليه عن خوض الانتخابات الرئاسية في 2018، رغم أنه لم يعلق على الأحداث بأي شيء رسمي.
الرئيس الذي يخلق الفوضى باسم الاستقرار
الخيارات الصعبة أمام السيسي.. كيف يسير إلى النهاية المحتومة؟

ويبدو أن السيسي في جولته الأخيرة لتضييق الدائرة حول المنظومة التي يعتبر نفسه ابناً لها وأكبر منها في الوقت ذاته، أكسب الجيش المصري بالتعديلات الدستورية الجديدة المزيد من النفوذ في الحكومة والسياسة بصفته «الحامي والوصيّ» على الدستور.
ففي 23 أبريل/نيسان 2019، شدد السيسي قبضته الديكتاتورية عندما وافق المصريون في استفتاء شعبي على مجموعة من التعديلات الدستورية التي منحته سلطات جديدة موسعة على القضاء والبرلمان بينما تسمح له البقاء في منصبه كرئيس للدولة حتى عام 2030.
نتيجة الاستفتاء الذي استمر ثلاثة أيام، كانت تتويجاً لما اعتبره المحللون تطوراً طبيعياً للخط الذي اتخذه السيسي وازداد وضوحاً باضطراد في السنوات الأخيرة. فالرئيس يقوم ببناء نوع من الاستبداد الذي لم يهدم المكاسب الديمقراطية لثورة 2011 فحسب ، بل تجاوز استبداد حسني مبارك الذي أُرغم على التنحي عن السلطة.
واتبع السيسي الذي يخوض ولايته الرئاسية الثانية منذ 2 أبريل/نيسان 2018، تدابير تقشفية اقتصادية تعصر الفقراء والطبقة المتوسطة التي هي من بقايا ما قدمه نظام مبارك هبة للمصريين تدريجياً خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه.
وبينما سمح مبارك ببعض الأصوات المعارضة والمنافذ الإعلامية المستقلة، تحرك السيسي لمنع أي نقد حتى وإن كان تلميحاً. فقد حكم على عشرات الآلاف من المعارضين ، وأغلق وسائل الإعلام الإخبارية وأبعد المعارضة من التدخل في السياسة.
السيسي أراد إجراء هذه التغييرات -بحسب ما يقوله المحللون- قبل أن تلقى شعبيته ضربة قوية بسبب المصاعب الاقتصادية التي بات يشعر بوطأتها الكثير من المصريين.
عندما قام السيسي برفع الدعم عن الوقود والكهرباء، ظن المحللون الاقتصاديون أنها خطوة أولى نحو بناء نظام اقتصادي أكثر استدامة. لكن السيسي لم يتخذ إلا عدداً قليلاً من التدابير الاستباقية. بدلاً من ذلك، ركز في الغالب على المشروعات الكبرى الضخمة، مثل توسيع قناة السويس، التي كلفت أكثر من 8 مليارات دولار، ورأى معظم الاقتصاديين أنه من غير المرجح أن تقدم الكثير من الفوائد في المستقبل القريب.
والسيسي، مثله مثل جميع العسكريين، يعتقد أن الاقتصاد عبارة عن مجموعة من المشاريع التي يديرها الجيش، كما يقول روبرت سبرينجبورغ، الخبير في شؤون الجيش المصري والذي يعمل حالياً باحثاً زائراً في جامعة هارفارد: «ليس لدى السيسي أدنى فكرة» عن الاقتصاد، يوضح لصحيفة نيويوركر: «العقلية العسكرية هي أيضاً عقلية دفاعية للغاية». فعلى عكس الصينيين الذين أبقوا عملتهم لسنوات عديدة على أقل من قيمتها، كوسيلة لجذب الاستثمار والتصنيع، أنفق المصريون قدراً كبيراً من الموارد المالية للبلاد على رفع قيمة الجنيه. وعندما ارتفع سعر السوق السوداء بالدولار الأمريكي ارتفاعاً حاداً، استجابت الحكومة المصرية بإجراءات جعلت من المستحيل التبادل بالسعر الرسمي للدولار. الشركات المصنعة مثل جنرال موتورز و L.G. أوقفت الإنتاج مؤقتاً؛ لأنها لم تتمكن من تحويل ما يدخل لهم محلياً إلى دولارات لدفع ثمن الأجزاء المستوردة.
يعيش أكثر من ثلث سكان مصر تحت خط الفقر، ومع ذلك ثمة نوع من الرؤية الفانتازية للتحسن الطفيف في الاقتصاد المصري خلال السنة الأخيرة.
نادراً ما يبدو أن المسؤولين الحكوميين يفهمون الموقف، ويعزى ذلك جزئياً إلى أنهم كانوا مشروطين بتاريخ طويل من الإعانات. فمنذ عام 1979 ، عندما وافقت مصر على معاهدة سلام مع إسرائيل ، قدمت الولايات المتحدة لمصر ما يقرب من 50 مليار دولار من المساعدات. المعدل الحالي هو حوالي 1.5 مليار دولار في السنة، ومعظمها من المساعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة وغيرها من المعدات. بطبيعة الحال يميل المستلمون إلى التركيز على هذه الأشياء بدلاً من التركيز على القضايا الاقتصادية الأكبر.
بعد الإطاحة بمرسي قررت إدارة أوباما عدم تسمية الحدث بأنه انقلاب، الأمر الذي كان سيؤدي إلى إلغاء تلقائي للمساعدات. كتدبير إجرائي، احتجزت الولايات المتحدة مؤقتاً بعض المعدات العسكرية الرئيسية. لكن هذه السياسة، بدلاً من إلهام التفكير العميق حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، أدت إلى التفكير أكثر من أي وقت مضى في قطع عسكرية لامعة. وكان السيسي في اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين يتحدث عن قطع الغيار التي تحتاجها دباباته، وليس اقتصاد بلاده.
قال دبلوماسي أوروبي لصحيفة نيويوركر: «لقد اعتدنا دائماً القول إن الأمريكيين الفقراء يقدمون ملياراً ونصف كل عام لمصر ولا يحصلون على أي شيء مقابل ذلك. حسناً، قدمت الإمارات والسعوديون 30 مليار دولار في غضون عامين ولم يحصلوا على شيء مقابل ذلك». لكن كل هذه الدول حصلت على ما دفعته بالضبط. لطالما كان الدافع وراءهم هو نظرتهم الضيقة للاستقرار: الولايات المتحدة تريد السلام بين مصر وإسرائيل، والخليج يريد السلام بين إيران والدول السنية الأخرى. كلهم يحتاجون حكومة مصرية تحارب التطرف الإسلامي. إذا كانوا يرغبون في استقرار حقيقي في مصر، فسيكتشفون أن عليهم أن لا يوجهوا غالبية تمويلهم نحو الجيش المصري، المؤسسة المحافظة التي لا تتمتع بخبرة في الاقتصاد أو التعليم أو السياسة.و ليس من المستغرب إذاً أن رجلاً عسكرياً مثل السيسي حقيقة يبني سياساته داخل مصر وخارجها بـ«عقلية دفاعية»، عقلية العسكري الذي يحصن نقاط ضعفه تجاه المشاكل التي تواجهه بدلاً من حلها.
ناصر، السادات، مبارك.. السيسي
في البلدان الديمقراطية، يحصل الحكام على الشرعية من صناديق الاقتراع، ويجددون ولاياتهم كل 4 أو 6 سنوات. على النقيض من ذلك، في الدول الاستبدادية يستغل القادة الثورات والحروب والنزاعات بين الدول لإضفاء الشرعية على حكمهم.
مصر تجسد هذا الاتجاه. لم تكن الانتخابات ذات أهمية تذكر لجمال عبدالناصر، قائد ثورة 1952، الذي قام بتحديث مصر. بينما استعاد السادات كرامة مصر بعبور قناة السويس في حرب 1973 مع إسرائيل، لكنه طلب من المصريين في استفتاء التصديق على مبادرة السلام التي لم تحظَ بشعبية. باستثناء النمو الاقتصادي وهزيمة التمرد الجهادي في التسعينيات، لم يكن لمبارك سوى القليل من الإنجازات الوطنية، ما أجبره على الاعتماد على الانتخابات لتوفير الشرعية. لهذا السبب استخدم الترهيب والقوة وتزوير الأصوات على نطاق واسع لضمان هوامش كبيرة من النصر في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
مثل ناصر والسادات، لا يؤمن السيسي بالانتخابات، واعتقد أن شرعيته تنبع من الانتصارات الشخصية، انتصاراته في إنهاء عصر الإخوان الصاخب و«إعادة الأمن إلى البلاد». لكنه يعلم الآن وقد خفت صوت الإخوان وعاد الأمن النسبي، أنه لن يستطيع اللعب طويلاً على هذا «الحبل»، فليست لديه رؤية سياسية مثل ناصر، ولا رؤية عسكرية أمنية مثل السادات، ولا يريد السير تماماً في طريق مبارك الذي رسم مسافة بينه وبين الجيش؛ خشية أن يلقى مصير سلفه السادات عندما اغتاله ضابط برتبة ملازم، فدفع برجال الداخلية للواجهة ومنحهم دوراً أكبر.
السيسي، ابن المنظومة العسكرية، الشاعر بأن «يداً إلهية ترعاه»، ظن بأنه سيترك بصمته الشخصية برؤية اقتصادية عندما شرع في فورة بناء تتضمَّن تشييد عاصمة إدارية جديدة بقيمة 58 مليار دولار، إلى جانب 13 مدينة جديدة إضافية. لكنه اضطر إلى اتباع برنامج تقشف قياسي مدفوع من صندوق النقد الدولي، عندما واجه مشكلات تمويل غير متوقعة، بعدما باتت الإمارات غير مستعدة لتحمل فواتير جديدة تضاف للفواتير الكثيرة التي تدفعها هنا وهناك.
السيسي يواجه أيضاً مشكلات سياسية وأمنية غير متوقعة. فقد انطلقت احتجاجات في أرجاء البلاد بعد ما كشفه محمد علي من إسراف وإساءة إدارة الأموال العامة واتساع نطاق الاستياء من حكمه وسياساته الاقتصادية. فردّت السلطات بموجة جديدة من الاعتقالات، وملء ميدان التحرير في القاهرة بالشرطة وقوات الأمن، الأمر الذي يبرز مخاوفه من إمكانية تكرار ما حدث مع مبارك.
على الأقل حتى الآن يبدو ذلك مستبعداً. فالمصريون سيترددون كثيراً قبل رؤية تحول بلدهم إلى سوريا أو ليبيا أو يمنٍ آخر. وهم أيضاً ليسوا طلاب العودة للديمقراطية التي تمتعوا بها إبان حكم مرسي. لكن الوضع تحت حكم السيسي أيضاً لا يمكن تحمُّله، فبدلاً من تقليص الدور الطاغي الذي يضطلع به الجيش في الاقتصاد المصري، وفتح الطريق أمام الأطراف الأخرى المتضررة من سياساته بنزع فتيل الاستياء الشعبي، فعل السيسي العكس تماماً. ليس ذلك فحسب، فابن منظومة الجيش ارتمى في حضن المنظومة تماماً وحرق جميع المراكب التي كانت تربطه بالأطياف السياسية المختلفة في مصر، حتى بات الليبرالي -مثله مثل الإخواني- عدواً في كفة ميزانه.
إما أنا أو البلد..
كان ينبغي أن تشكل وفاة محمد مرسي في قاعة محكمة بالقاهرة نهاية مرحلة قاد فيها الرجل لفترة وجيزة الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان. ورغم أنه لم يكن سوى رئيس شكلي من نواحٍ عديدة، فإنه عكس فشل أو «إفشال» -والأمران سيّان- جماعة الإخوان المسلمين في الانتقال من الحكم الاستبدادي إلى السياسات الديمقراطية بمصر. ومن غير المرجح أن تؤدي وفاته إلى إضعاف الجماعة المتداعية أصلاً، إلا أنها كانت فرصة جيدة للسيسي لتخفيف القيود الصارمة التي تخنق الحريات في عهده.
لكن بالنظر إلى التركيبة الاستثنائية لولادة «الرجل» الذي يحظى بـ«عناية إلهية»، من المستبعد أيضاً أن يخفف السيسي قبضته على الحريات بعد استعادته المنصب التقليدي لرئيس مصر بوصفه وليّاً على الدولة.
الأحزاب القائمة ضعيفة للغاية ولا يسمح لها بتجنيد الأعضاء أو المناصرين بشكل منتظم. كما أن القوانين التي تهدف إلى الحد من التأثير الأجنبي قد فككت المنظمات غير الحكومية. ورغم أن سياسات السيسي لا تزال تلقى رواجاً بين بعض المصريين، لأنهم يعتقدون أنه جلب الأمن إلى البلاد، فإن استطلاعات الرأي تظهر أن الشباب أكثر تشككاً فيه من المصريين الأكبر سناً. فما يقرب من 60% من السكان هم دون سن الثلاثين، وهم الذين هيمنوا على الاحتجاجات الأصلية في ميدان التحرير في 20 سبتمبر/أيلول 2019. وهم أيضاً يشكلون الكتلة الرئيسية في مجال الصحافة. والأهم من ذلك أن الشباب يمثلون القطاع الأكثر تضرراً من أكثر نقاط الضعف لدى السيسي: سياساته الاقتصادية.
من دون أحزاب حقيقية، ومؤسسات سياسية حقيقية، وسياسيين محترفين حقيقيين، لا تبقى سوى خيارات تكاد تكون معدومة أمام الشباب المصري للمشاركة في الحياة السياسية، ما عدا اللجوء للاحتجاجات في الشوارع.
الاستقرار السياسي على المدى الطويل يتطلب تغييراً اقتصادياً واجتماعياً. وإذا كانت دولة ما تمول السيسي وتعتمد عليه كمصدر للاستقرار، فهو دائماً ما يخفق في خلق وظائف مستدامة للشباب المصري. والنتيجة أنه جعل أي صيغة من الإصلاح السياسي والاقتصادي والأيديولوجي التدريجي الفعَّال، شبه مستحيلة. وهو يريد تقديم خيارين للمصريين، كما فعل الرئيس السوري بشار الأسد من قبله: الأسد أو نحرق البلد.
السيسي يتجه فعلاً للخيار الثاني، فقد حشد الآلاف من رجال الأمن وأنصاره والإعلام المؤيد الجمعة الماضية، وتراجعت الاحتجاجات المناهضة له وبدت أضعف من سابقتها. لكن محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قال لصحيفة نيويورك تايمز: «الاعتقالات والإجراءات الأمنية المشددة قد أخافت الناس، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الزخم الذي حدث الجمعة الماضية قد انتهى»، مضيفاً أنه سيكون من الصعب على الحكومة الحفاظ على هذا المستوى من الأمن إلى أجل غير مسمى.
ميشيل دون، الباحثة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، قالت إنه بالنظر إلى مخاطر المعارضة في مصر، حتى الاحتجاجات المتواضعة تمثل تحدياً مذهلاً لسلطة الرئيس. فضلاً عن أنه من الصعب التنبؤ بمستقبل هذه الاحتجاجات بسبب تركيبتها، إذ معظمها من الشباب الذكور، ولا شيء لديهم ليخسروه.
بالتأكيد هم ليسوا منظمين، وليست لديهم مطالب واضحة سياسياً سوى إسقاط السيسي. والإجراءات الأمنية لن تردعهم على المدى الطويل. فكلما فرقتهم قوات الأمن سيعيدون تجميع أنفسهم ويخرجون مجدداً عندما تكون هناك فرصة سانحة. لقد تم كسر حاجز الخوف، ولن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل ذلك.










أوزيماندياس - رمسيس العظيم
اللحظة الفارقة في تاريخ مصر

هذه لحظة فارقة في تاريخ مصر، إن لم يدرك السيسي هذا -ولا يبدو أنه ينوي ذلك- سيذكّره الشاعر الإنجليزي بيرسي شيلي بقصيدته المشهورة أوزيماندياس - رمسيس العظيم، في دعوة للتأمل في مصائر السلطة، وما زعمه ملك الملوك وكيف آلت مملكته..

تمثال أوزيماندياس - رمسيس العظيم
تمثال أوزيماندياس - رمسيس العظيم
أوزيماندياس - رمسيس العظيم
لقيتُ رَحّالة قادماً من بِلادٍ عَتيقة
قالَ لي: ثَمَّة ساقان حَجَريَّتان عِملاقتان لا جِذعَ فَوْقَهُما
تنتصبان في الصحراء. وقُرْبَهُما وَجْهٌ مُهَشَّم،
نِصْفُهُ غارقٌ في الرمال، تَدُلُّ نَظرَتُه
والتِواءُ شَفَتِه وتَعْبيرُ السَّيطرةِ الباردة البادية عليه
أنَّ النَحّاتَ أجادَ إدراكَ كُنْه تلكَ المشاعر
التي ما تزالُ باقية، مطبوعة على هذا الجَماد،
اليَدُ التي سَخِرَتْ منها والقلبُ الذي رعاها.
وعلى القاعدة تَظهرُ هذه الكلمات:
«اسمي أوزيماندياس، مَلِكُ المُلوك:
أنظرْ إلى مُنجزاتي، أيها الجبار، وابتئِسْ!»
ولا شيءَ باقياً بجانبه. وحَوْلَ خَراب
ذاكَ الحُطام الهائل، عارية وبلا حدود،
تمتدُّ الرمالُ المنعزلة والمستوية على مَدِّ البَصَر.
القصيدة من ترجمة العراقي غسان نامق
قصيدة أوزيماندياس
قصيدة أوزيماندياس